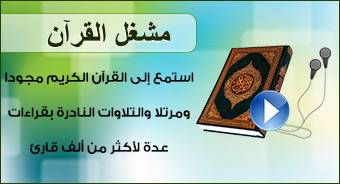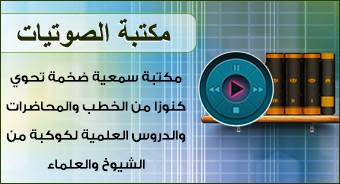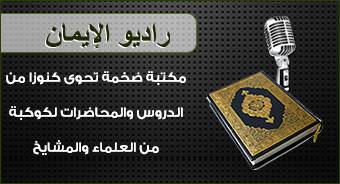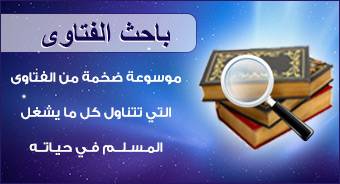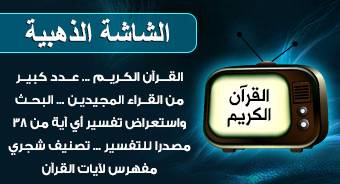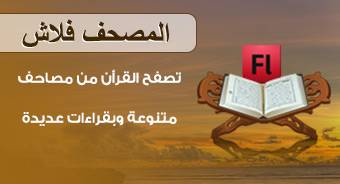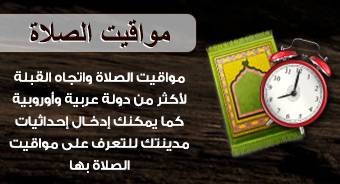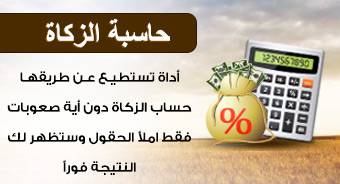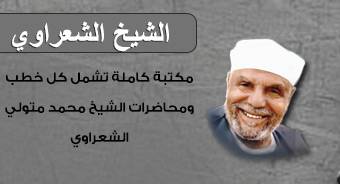|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
السابعة عشرة: قوله تعالى: {لاَّ تُلْهِيهِمْ} أي لا تشغلهم.{تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ الله} خصّ التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل بها الإنسان عن الصلاة.فإن قيل: فلمَ كرّر ذكر البيع والتجارةُ تشمله.قيل له: أراد بالتجارة الشراء لقوله: {ولا بيع}.نظيره قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْاْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] قاله الواقدي.وقال الكلبي: التجار هم الجُلاّب المسافرون، والباعة هم المقيمون.{عَن ذِكْرِ الله} اختلف في تأويله؛ فقال عطاء: يعني حضور الصلاة؛ وقاله ابن عباس، وقال: المكتوبة.وقيل عن الأذان؛ ذكره يحيى بن سلام.وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى؛ أي يوحدونه ويمجّدونه.والآية نزلت في أهل الأسواق؛ قاله ابن عمر.قال سالم: جاز عبد الله بن عمر بالسّوق وقد أغلقوا حوانيتهم وقاموا ليصلّوا في جماعة فقال: فيهم نزلت {رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ} الآية.وقال أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله.وقيل: إن رجلين كانا في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، أحدهما بياعًا فإذا سمع النداء بالصلاة فإن كان الميزان بيده طرحه ولا يضعه وَضعًا، وإن كان بالأرض لم يرفعه.وكان الآخر قَيْنًا يعمل السيوف للتجارة، فكان إذا كانت مِطْرقته على السَنْدان أبقاها موضوعة، وإن كان قد رفعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع الأذان؛ فأنزل الله تعالى هذا ثناء عليهما وعلى كل من اقتدى بهما.الثامنة عشرة: قوله تعالى: {وَإِقَامِ الصلاة} هذا يدلّ على أن المراد بقوله: {عن ذكر الله} غير الصلاة؛ لأنه يكون تكرارًا.يقال: أقام الصلاة إقامةً، والأصل إقوامًا فقلبت حركةُ الواو على القاف فانقلبت الواو ألفًا وبعدها ألف ساكنة فحذفت إحداهما، وأثبتت الهاء لئلا تحذفها فتُجْحف، فلما أضيفت قام المضاف مقام الهاء فجاز حذفها، وإن لم تضف لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول: وَعَد عِدَة، ووَزَن زِنَة، فلا يجوز حذف الهاء لأنك قد حذفت واوًا؛ لأن الأصل وَعَد وِعْدَةً، ووَزَن وِزْنة، فإن أضفت حذفت الهاء، وأنشد الفراء:
يريد عِدَة، فحذف الهاء لما أضاف.وروي من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنها نُجُب بيض قوائمها من العنبر وأعناقها من الزعفران ورؤوسها من المسك وأذِمّتها من الزبرجد الأخضر وقُوّامها والمؤذنون فيها يقودونها وأئمتها يسوقونها وعُمّارها متعلقون بها فتجوز عَرَصات القيامة كالبرق الخاطف فيقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقرَّبون أو أنبياء مرسلون فينادَى ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم».وعن عليّ رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله خراب، شرُّ أهلِ ذلك الزمن علماؤهم، منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود؛ يعني أنهم يعلمون ولا يعملون بواجبات ما علموا.التاسعة عشرة: قوله تعالى: {وَإِيتَاءِ الزكاة} قيل: الزكاة المفروضة؛ قاله الحسن.وقال ابن عباس: الزكاة هنا طاعة الله تعالى والإخلاص؛ إذ ليس لكل مؤمن مال.{يَخَافُونَ يَوْمًا} يعني يوم القيامة.{تَتَقَلَّبُ فِيهِ القلوب والأبصار} يعني من هوله وحذر الهلاك.والتقلّب التحوّل، والمراد قلوب الكفار وأبصارهم.فتقلب القلوب انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر، فلا هي ترجع إلى أماكنها ولا هي تخرج.وأما تقلب الأبصار فالزَّرَق بعد الكَحَل والعَمَى بعد البصر.وقيل: تتقلّب القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك، والأبصار تنظر من أيّ ناحية يعطَوْن كتبهم، وإلى أي ناحية يؤخذ بهم.وقيل: إن قلوب الشاكين تتحول عما كانت عليه من الشك، وكذلك أبصارهم لرؤيتهم اليقين؛ وذلك مثل قوله تعالى: {فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ اليوم حَدِيدٌ} [ق: 22]؛ فما كان يراه في الدنيا غَيًّا يراه رُشْدًا؛ إلا أن ذلك لا ينفعهم في الآخرة.وقيل: تقلّب على جمر جهنم؛ كقوله تعالى: {يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النار} [الأحزاب: 66]، {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ} [الأنعام: 110].في قول من جعل المعنى تقلّبها على لهب النار.وقيل: تقلب بأن تلفحها النار مرة وتُنْضِجها مرة.وقيل إن تقلب القلوب وَجِيبها، وتقلّب الأبصار النظر بها إلى نواحي الأهوال.{لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ} فذكر الجزاء على الحسنات، ولم يذكر الجزاء على السيئات وإن كان يجازي عليها لأمرين: أحدهما: أنه ترغيب، فاقتصر على ذكر الرغبة.الثاني: أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة.{وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ} يحتمل وجهين: أحدهما: ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها.الثاني: ما يتفضل به من غير جزاء.{والله يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} أي من غير أن يحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا نهاية لعطائه.وروي أنه لما نزلت هذه الآية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء مسجد قُبَاء، فحضر عبد الله بن رَوَاحة فقال: يا رسول الله، قد أفلح من بنى المساجد؟ قال: «نعم يا ابن رواحة» قال: وصلّى فيها قائمًا وقاعدًا؟ قال: «نعم يا ابن رواحة» قال: ولم يَبِت لله إلا ساجدًا؟ قال: «نعم يا ابن رواحة كفَّ عن السّجْع فما أعطى عبد شيئًا شرًا من طلاقة في لسانه» ذكره الماوَرْدي. اهـ.
والثاني: أنهم ذوو تجارة وبيع ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله وعما فرض عليهم، والظاهر مغايرة التجارة والبيع، ولذلك عطف فاحتمل أن تكون تجارة من إطلاق العام ويراد به الخاص، فأراد بالتجارة الشراء ولذلك قابله بالبيع، أو يراد تجارة الجلب ويقال: تجر فلان في كذا إذا جلبه وبالبيع البيع بالأسواق، ويحتمل أن يكون {ولا بيع} من ذكر خاص بعد عام، لأن التجارة هي البيع والشراء طلبًا للربح.
|